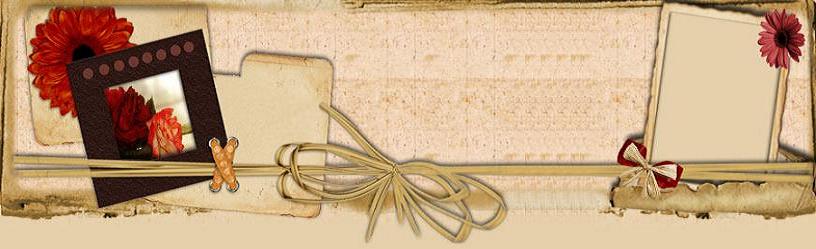صهيل الأيام الخوالي
"بردت قهوتنا..
وانتهت قصتنا.. وانتهى الحب الذي كان..
نزار قباني
الردهة فسيحة، والستائر مسدلة، وصمت ثقيل يلف المكان، لا يخدشه إلا صوت خشخشة صفحات الجريدة التي يطالعها بكثير من الملل، وبشعور خانق يجثم فوق صدره، وكأنه يكتشف إحساساً مغايراً للمرة الأولى.
هل تمضي الحياة هكذا وهو يعد أيامها الرتيبة وكأنه يبحث في أعماقه عن أمور يفتقدها ولا يجد لها في الواقع بديلاً بينما الجُواء حوله تزداد برودة وضبابية؟
وهذه المرأة التي تقبع قبالته على الأريكة الوثيرة وهي تنسج الصوف، من هي.
هو يعرف أنها زوجته، ولكن، لماذا هذه الغربة القاتلة القائمة بينهما؟ إنها الجلسة اليومية المكرورة.. تأتيه بالجريدة وبفنجان القهوة، وتجلس قبالته صامتة وهي تحيك الصوف..
الردهة فسيحة، والستائر مسدلة، والتلفزيون صامت، وهدوء موحش يخيم بدوره على غرف الأبناء الذين كبروا، وتزوجوا، وسافروا إلى دنيا الله الوسيعة..
البيت الذي كان يضج بالمرح والحياة، أصبح أشبه بمتحف لا يغشاه إلا الذين بلغوا أعتاب الشيخوخة ولم يعد هناك ما يثير اهتمامهم إلا الرُقم الصامتة والتماثيل الباردة..
ولكنهما، هو وزوجته، لا يزالان في بداية مرحلة الكهولة، وهي ليست بعيدة، كثيراً عن ذروة الشباب التي ودعاها منذ أعوام قليلة، إذن.. لماذا هذا الموت المبكر؟ أين ذلك الصهيل الذي كان يأنسه في نفسه عندما يعود إلى البيت مفعماً بالحيوية والتوق إلى مجالسة رفيقة عمره التي تستقبله خفيفة، رشيقة، عذبة المبسم؟
ينظر إليها وهي جالسة تحيك الصوف وكأنه يحاول أن يتعرف إليها من جديد.. لقد ترهلت وهي ابنة الخامسة والأربعين.. أهملت نفسها.. تركت الرياضة التي كانت تمارسها، ولم تعد تراعي التوازن في طعامها..
ولكن.. ألم يفعل هو مثلها؟ وإلاّ، فما حكاية هذا الكرش المندلق أمامه وهو لا يزال في الخمسين؟
هل لأنها لم تعد تتزين له، فأهملت العطر الذي يحبه والثياب الزاهية التي كانت ترتديها من أجله؟
يبدو أن ما حدث يتعدى هذه الأمور.. هناك وشائج أخرى تتراخى مع الأيام.. تجعل الزوجين يتراخيان على الأرائك في الزوايا تحت ظل الصمت المريع والأسئلة الضائعة في جو ردهة الجلوس دون أجوبة، وكل منهما يبحث عبثاً في أعماقه (لا شك أنها تعيش المشاعر نفسها والتساؤلات نفسها) عما يتصوره لغز الحياة الزوجية الذي يبدأ بسنوات الحب التي تتطاير عصافير السعادة في جوائها، وتصدح الموسيقى بين جدرانها، وتتواءم فيها أحلام العِشرة مع الفرحة العارمة بقدوم الأطفال الذين يكرجون بين الغرف في ظل طمأنينة بادية يوفرها رب الأسرة، ذو الصهيل العالي الذي يجسد حضور الفارس.
ثم.. ثم تتلاشى هذه الأصوات كلها، فتبهت الصورة، ويتطامن الصهيل العالي، وتتداعى الجدران حيث لا ينفع فيها مسند ولا ترميم.
لأول مرة، يخرج عن الاهتمام بالمتابعة اليومية للأنباء في جريدته المختارة، ويبدأ في أعماقه مونولوج الخيبة عن هذا الإيقاع البطيء والصمت المطبق والليالي الموحشة التي تكتنفها هبات رياح خريفية.
سيقنع نفسه بأن الأمر لا يتعدى أن يكون نوعاً من منطق الحياة، تجسده مأثورات متوارثة عن الأسلاف: "لكل عمر روعته وبهجته".. أو "لا تحاول أن تأخذ زمنك وزمن غيرك" ولكنه لا يزال يشعر أنه في عنفوان الشباب.. وأنه لا يزال قادراً على إطلاق الصهيل الذي يهز أركان هذه الجدران الباردة، فلماذا لا تكون هي كذلك؟ لماذا هذه الاستكانة إلى أريكة حياكة الصوف والانشغال عنه وعن الدنيا بأخبار الأبناء ورسائلهم، واختيار الهدايا لإرسالها إلى أطفالهم؟ لماذا لم تعد الأنثى التي تعطر حوله الجُواء؟ من قال أن المرأة يجب أن تنتهي في السن التي يجب أن تزداد فيها تألقاً؟
سخرت منه مرة عندما قال لها أنه لا يزال يحلم ويطمح ويخطط للمستقبل.. حاولت أن تقنعه بأن الرحلة في نهايتها، وما على الإنسان إلا أن يستكين ويهدأ بانتظار حسن الختام.
من قال أن استنفاد المباهج التي وفرها الله للإنسان حتى قطراتها الأخيرة ليس نوعاً من حسن الختام؟
ومرّة.. رمى إليها بكلمات أرادها نوعاً من الغزل، فركبها خجل غريزي وهي تقول له ممازحة: هل عدت إلى المراهقة يا أبا الشباب؟
ولكن.. ألا يظلمها عندما يرمي عليها تبعة كل ما حدث؟ ألم تكن شريكة حياته في السراء والضراء؟. ألم تكن الزوجة المثالية والأم الرؤوم؟ ومن يدري كم من المعاناة والمرارة تدفن في صدرها وقد تغّرب عنها أبناؤها وهي تقوم بواجباتها اليومية كاملة غير منقوصة؟
ولكن.. هل الحياة أريكة وثيرة وطعام شهي وفراش نظيف؟ ألا يتوفر هذا في أي مطعم أو فندق؟ أين هي تلك الطيور الملونة التي كانت تحلق في سماء حياتهما؟ تلك النسمات الربيعية التي تنعش القلب؟ تلك اللحظات الراعشة من المفاغمة الماتعة التي تختصر فرح الأيام؟
لماذا يتحول القمر إلى هدف برامج الفضاء بدل أن يكون أنيس الأحبة وجليسهم؟ لماذا لا تنهض هذه المرأة التي أمامه وترمي من يدها النسيج الصوفي الذي تحيكه، وتضغط زر آلة التسجيل وتدور أمامه في الردهة دورة راقصة ثم تشد من يده الجريدة وتدعوه لجلسة سمر.
لماذا يختنق جالساً بدل أن يطلق صهيله يملأ كل الغرف؟ ها هي الغيوم متلبدة في سماء أيامه.. رمادية.. سوداء.. ولا من نسمة باردة تداعبها لتهطل مطراً ربيعياً على حياته الجديبة؟ هل يصارحها بما يعتمل في نفسه؟… ولكن.. ماذا سيقول لها؟ ليس بينهما لغة مشتركة يمكن أن يحقق من خلالها هذا النوع من التواصل.. لعلها ستسخر منه ومن أفكاره وتعود إلى التهمة القديمة.. ستتهمه بالمراهقة، وتطلب إليه أن يقوم إلى غرفة المكتب يجيب على رسائل الأبناء وبطاقات الأحفاد، بدل أن يشغل باله بمثل هذا النوع من أضغاث الأحلام.. أحلام اليقظة التي جاءت متأخرة.
بل قد ترد بنوعٍ من الحسم: إذا لم أعد أعجبك، طلقني، وتزوج واحدة أخرى.. بل أنا مستعدة لاختار لك عروساً شابة تتناسب مع هذا الصهيل المزعوم الذي لا تقتنع أنه أصبح نوعاً من الصدى القادم من الوديان السحيقة.
أطلقها؟ أتزوج واحدة أخرى؟ لا.. هذا مستحيل ليس هذا ما يؤرقني.. ولست أنا الذي يفعل هذا مع رفيقة العمر التي ظلت بين يدي كل هذه السنين الطويلة (شبيّك لبيك).. تعرف أنني أحب شرب القهوة ساخنة، فتحضر الفنجان وركوة القهوة وتسكبها والبخار يتصاعد منها.. لم أفتقد يوماً زراً في قميص، ولا بذلة مكوية، ولا زهرة القرنفل التي أحب أن أراها في مزهرية على مائدة الطعام.. لا تتناول العشاء قبل أن أعود إلى البيت، حتى لو كنت ساهراً إلى ساعة متأخرة من الليل.. لم تحاصرني بالكلمات الملحة.. ولا بالأسئلة السخيفة، ولا حتى بالغيرة العمياء التي تجابه بها الزوجة زوجها عادة.
هل أكافئها بالطلاق؟ وبالزواج من شابة صغيرة تتعطر بالعطر الذي أحب، وتدور في الردهة أمامي على الأنغام المنبعثة من آلة التسجيل دورات راقصة؟
سأفاجئها غداً بهدية.. سأشتري لها الإسوارة التي أحبتها يوماً واشتريتها لها، فأهدتها إلى ابنتها في يوم عرسها.. والآن.. عليّ أن أعود إلى الجريدة.
وقبل أن يتابع المطالعة مدّ يده إلى فنجان القهوة، ورشف رشفة واحدة، ثم أعاد الفنجان إلى مكانه.. كانت القهوة قد أصبحت باردة.